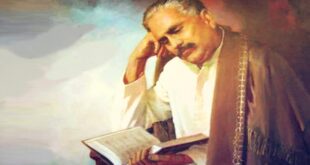الإطار السوسيوـ تاريخي للجدل حول السلطة الدينية والزمنية
د: رشيـــد بوسعـادة
جامعة بوزريعـة ) الجزائر(
ملخص:
إن موضوعي السلطة الدينية والسلطة الزمنية لم يقتصرا على مسار واحد ولم يطرحا من جانب واحد بل أخذا أطرا متعددة وأبعادا متنوعة تبعا للتخصصات، وتناول هذين العنوانين تم تحت مفاهيم متنوعة ومتضاربة غير أنها موحدة في مضمونها، فتارة تطرح على الشكل السالف الذكر [السلطة الدينية والسلطة الزمنية]، وطورا بعنوان: علاقة الدين والسياسة ومرة أخرى بعنوان: علاقة الدين والدولة، وتشعب التناول إلى مشارب متعددة تعكس الطابع المنهجي والمقاربات مرورا بالبعد الإيديولوجي، إلا أننا نختصر هذا في حدث الدين كظاهرة اجتماعية وعلاقتها بالأنساق الاجتماعية وكيف تتفاعل فيما بينها وسنبدأ بطرحها تحت علاقة الدين باللائكية الذي يلخص قانون الدين ومسار بروز اللائكية ثم الإسلام والسياسة إلى أن نصل إلى معالجة إشكالية الدين بالدولة من خلال طروحات متعددة
resumé
Les deux thèmes de l’autorité religieuse et du pouvoir temporel ne peuvent être confondus ni abordés sous un même angle, cependant, ces derniers seront traités dans leurs différents contextes à travers de multiples dimensions en fonction des différentes spécialités.
Le traitement de ces deux thèmes a été réalisé à travers divers concepts qui semblent parfois contradictoires mais cependant leur contenu est un : ils sont parfois exposés à travers la forme précitée (Autorité religieuse/pouvoir temporel) ou encore sous forme de relation religion/politique, ou religion/état.
L’enchevêtrement de l’analyse dans le traitement de ces deux thèmes reflète l’aspect méthodologique. En fait, ils sont imprégnés d’idéologie.
Nous résumons cette problématique à travers le fait religieux en tant que phénomène social et ses relations avec les systèmes sociaux et leur interactivité.
Nous commencerons par traiter la relation qui existe entre la religion et la laïcité qui résume la loi de la religion et l’avènement de la laïcité.
Enfin par suite, nous aborderons le rapport islam/politique pour pouvoir traiter la problématique religion/état à travers de multiples analyses.
إن موضوعي السلطة الدينية والسلطة الزمنية لم يقتصرا على مسار واحد ولم يطرحا من جانب واحد بل أخذا أطرا متعددة وأبعادا متنوعة تبعا للتخصصات، وتناول هذين العنوانين تم تحت مفاهيم متنوعة ومتضاربة غير أنها موحدة في مضمونها، فتارة تطرح على الشكل السالف الذكر [السلطة الدينية والسلطة الزمنية]، وطورا بعنوان: علاقة الدين والسياسة ومرة أخرى بعنوان: علاقة الدين والدولة، وتشعب التناول إلى مشارب متعددة تعكس الطابع المنهجي والمقاربات مرورا بالبعد الإيديولوجي، إلا أننا نختصر هذا في حدث الدين كظاهرة اجتماعية وعلاقتها بالأنساق الاجتماعية وكيف تتفاعل فيما بينها وسنبدأ بطرحها تحت علاقة الدين باللائكية الذي يلخص قانون الدين ومسار بروز اللائكية ثم الإسلام والسياسة إلى أن نصل إلى معالجة إشكالية الدين بالدولة من خلال طروحات متعددة.
إن التفاعل الاجتماعي مع مسألة الديانات يحظى بعناية جيدة تغطي مختلف الرهانات على الأقلمن جانبها التوافقي وفي بعض الأحيان هو قابل للوسائلية الآنية، ولا تزال تطالعنا الأحداث إلى يومنا هذا منذ فلسفة التنوير، والنقاش الذي جرى في فرنسا حول معاينة إدراج الديانات في النسق التربوي سنة” 1986 “(*1) حيث عبر فاعلو النسق التربوي من خلال وسائل الاتصال المكتوبة والمسموعة عن تشاؤمهم من نقص الثقافة الدينية للطلبة مما يصعب فهم بعض المواضيع الأدبية والفلسفية وباختصار نقص المرجعية الثقافية، وهذا ما أدى إلى ما يمكن أن نسميه الأزمة الإنسانية أزمة الممارسة الدينية.
إن الطبيعة الدينية تسجل وترتبط بالأنماط الاجتماعية التاريخية في علاقتها مع الإطار الحضري وطبيعة نموها، إذن في هذا المعنى بإمكاننا تقديم فكرة عن المجتمعات الأكثر تدينا أو الأقل تدينا عن غيرها، ومن الجلي أن النظام الديني يمثل إحدى أبنية أو أنساق الوعي البشري “(فالإنسان لم يضح سياسيا إلا لكونه دينيا”)، وبذا يشكل الدين عنصرا في وحدة الجماعة، فهو مرتبط بالهيكل الاجتماعي والتنظيم السياسي، ونشير في تاريخ بداية الدين أن الدين لا يمكن بالفعل أن يغمر كل الحياة، “فمن الضروري التمييز بين الدين والتاريخ الديني أي بين الدين في تجريده وقصديته وممارسة الدين”(2) وفي هذا الإطار يمكن القول بأن التيوقراطية تشكل الفعل الأول لاستعادة السياسة للدين بتقمص السياسي للدين.
إن خلط السياسي بالديني ينزع نحو إذلال هذا الأخير في حدود التحركات الميكيافلية فإذا كان يتطلع إلى العالمية فالسياسي يفترض الاختلاف وتنظيم المنافسة ( فالأشكال الدينية دائما إذن هي وظيفة للدولة والحضارة)3 مما يدل على أن نسق السلطة لا يتصف بالبقاء والثبات مما يدفع الإنسان إلى فك أسره من هيمنة عالم المقدس ولا يعمل على استرضاء الأرواح ولا يقوم بالالتزام لسلطة لا تمجد عقله أو ما يسميه “شيلر” (عالم الرشد) (4)إذن هي شرعية المجال الحي الذي تمارس فيه السلطة والتي تتصف بالسيطرة معتمدة في ذلك على القهر الفيزيقي أو المنفعة، فبهذا التفاعل الذي يتم بين الفئتين الحاكمة والمحكومة تفرز من خلالها شرائح أخرى لها دورها في ممارسة هذه السلطة مجسدة في مشروعية القوة والنفوذ والتي يلخصها “فيبر” بـ(ثلاثة نماذج من أنساق المعتقدات القانونية التقليدية والملهمة) ولذا قبل التطرق لهذا بالتحليل، نستهل بالسؤال التالي:
هل لهذه الأنظمة السلطوية القدرة على إيجاد التزامات وأفكار تعكس صورة العلاقات الاجتماعية الجديدة التي تنتجها ومن خلالها تتقمص الحركة الاجتماعية مصدرها السلطوي بحيث تستمد فقهها من القواعد الضابطة لمشروعيتها فتلزم أصحابها بقداستها على حساب تحطيم النظم القديمة التي تحل محلها، مما يعمل على حمل ونقل الأشكال الجديدة للسلطة والالتزام بها، إلا أن هذا لايتم في حقيقة الأمر بسهولة حتى من السلطة “النبوية” لأنها تطرح مشكلة عائق التغير التي تجبرها بالبرهنة عن شرعيتها وتفنيد ادعاءات منافسيها، وبطبيعة الحال سيكون للسلطة الزمنية النصيب الأوفر، وهذا بقوة رجالها وحيلها مع جهلهم بالدين، ولا ننسى أن بعض الأحزاب نشأت في كنف الدين مثل “البروتستنت” التي تعرف بأنها حركة إصلاح ديني وتحمل في باطنها البذور الأولى وبداية الخط للنظام الحزبي الحديث. وعلى سبيل المثال حزب البيوريتان كان أساسه دينيا، قام على أساس صراع ديني ومطالب دينية تختلف في شأنها مع السلطة الموالية للكاثوليك
وكان ذلك نتاج المراحل التاريخية التي تقمصتها اللائكية في تطور الفكر والمجتمع انطلاقا من توظيف الديني للسياسي والى تجهيز السياسي للديني، وتترجم الحركة اللائكية في أنها نقل الفكر الديني إلى الفكر الوضعي ومن أجل هذا السبب فإن هذه الحركة تمثل إشعاع موجة الحداثة والحرية اللتين تشكلان القيم الأخلاقية العالية للائكيه “(5)، ويرسم التمييز بين اللائكية والثقافة اللائكية استجابة لمتطلبات الإدراك العالمي، فاللائكية كتعبير سياسي موسوم بخصائص ثقافية، لانستوفي الغرض منه حتى نتمكن من فهم اللائكية في كليتها.
تعني اللائكية التمييز بين الزمني والروحي لكن لا تعني في أي لحظة قوة تستخدم ضد أخرى بل هو تمييز في المهام، ولعل عالمية اللائكية تكمن في خصوصيتها المجردة والمتعالية لمبادئها وليس في أحاديتها التاريخية بالنسبة لمرجعيتها بل لتجارب تاريخية وسياسية، ولا يمكن تصور اللائكية إلا في أفق ترجمة مفتوحة ودائمة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة للتطور الإنساني حتى نتجنب خطر مفهوم المذهبية اللائكية(6)، وهناك من تعرض إلى مفهوم جديد لتحديد العلاقة بين المفاهيم السالفة الذكر فقد اقترح فرايد” نموذجا يعتمد عليه كقاعدة في تحليل النبؤية في علاقته مع السياسة، حيث يميز بين “النبوئية المدعية ” و”النبوئية المرسلة” الأولى حادثة سياسية عارضة والثانية سياسية للغاية حيث يرتب الإسلام في الفئة الأولى، وهذا ناتج عن رؤى الفلاسفة الذين يضعون مشكلة العلاقة بين الدين والسياسة في مركز تفكيرهم ويعتبرون الدين كأنه أساس ونهاية الدولة، أما بوسي فيقول: أساس الدولة ديني وأصل السلطة رباني أو سماوي”(7) ، أما جوزاف دي ميستي Joseph demister فإنه ينادي بوحدة الدين والسياسة في المسيحية وأن على المجتمع أن يعود إلى أصله، أما ميكيافيلي ففي نظره يجب أن يكون الدين في خدمة السياسة وهذا هو مفهوم المنفعة للدين، وكذا منتسكيو كان يمنح ذلك للوظيفية الاجتماعية والسياسية للدين وأن الفصل بين الدين والسياسة هو فصل شفوي فالسلطة هي نفسها مقسمة وهناك خطر دائم إذا قسمنا ذلك مع سلطة أخرى، وهذا ما سنتعرض له عند بعض الكتاب الذين تناولوا ذلك في الخلافة الإسلامية أي بالضبط في عهد معاوية وما بعده، أما سبينوزا فيرى خضوع الدين للسياسة ولا يجب التميز بين الفكر والفعل، والإيمان الداخلي والشعائر الخارجية كما يرى بأن السلطة الكهنوتية تشكل عائقا للمجتمع السياسي بحيث تحد من قوة فعله”(8)
وفي الواقع فإن الوجه الخفي للسلطة يكمن في تعليل الساسة لمؤسسة الكنيسة، ونرى هنا أن سانت أوغيستن كان أول منظر سياسي مسيحي يرى “بأن هيكل السياسية أو قطاع السياسة كان من عمل الإنسان إذن هو سيئ والسلطة هي عقوبة للخطيئة أصلا، أما “لوك” Jean look فأغلى شيء عنده هو الفصل بين الكنيسة والدولة، بل يرى توكفيل الصلح بين الكنيسة والديمقراطية أما أوغيست كونت فنادي بديانة جديدة عالمية واعية بالخطر (وهي الفوضى الروحية للشعوب الحديثة ولذا تنادى بسلطة روحية جديدة قادرة على الإجابة أو إشباع حاجيات الدولة العلمية والوضعية(9) وهذا الفصل أساسي بين النظرية والممارسة والفكر والفعل، كل هذا يدعو إلى أن مسألة السلطة بين الدين والسياسة مسألة معرفية قديمة قدم الفكر، بل هي محور الحراك الفعلي للمجتمع وما تتضمنه أنساقه من وظائف تبنى عليها سلوكيات محددة لمفاهيم كبرى لدى الفرد والمجتمع من بينها الدين والسياسة والدولة والسلطة…الخ. إلا أنه يصعب علينا إلى حد الآن الكشف عن حركية البناء الوظيفي لآليات التفاعل المولِّدة للتجربة الدينية والسياسية في مسيرة المجتمعات والتي تشكل الوعي التاريخي المحدد لها.
إن تقسيم العالم إلى مجالين يتضمنان كل ما هو مقدس وكل ما هو “دنيوي” يعد خطوطا فاصلة ومميزة للفكر الديني وهذه الازدواجية أو الثنائية المضادة “المقدس والدنيوي” تشكل البنية الأساسية التي تدور حولها الأنظمة الدينية، وحسب دوركايم فالمقدس هو جوهر الدين أما الدنيوي هو ما يقع خارج مجال المقدس” كل المعتقدين دينيا يعرفون أن الدِّين مهما كان بسيطا أو معقدا فإنه يقدم نفس الخاصية المشتركة، بحيث يفترض ترتيب الأشياء واقعيا أو مثاليا حيث يعرضون الأشخاص في طبقتين ذواتيْ نمطين متعارضين يدل عليهما عموما بلفظين متميزين تترجم فعلا لفظا الدنيوي والمقدس، ويعرف كل من الدنيوي والمقدس بتعارضهما وتناقضهما وكلاهما يأتي بجملة معيارية تتعلق بالأطر الثقافية(10).
يمثل الهروب إلى الجانب الروحي بالنسبة للدين ابتعادا ونقاء لمادية العالم والوسيلة التي تسمح للبشرية بالصعود إلى العالم الأعلى عالم الإنقاذ، لأن المثالي لا يتحقق في العالم الأدنى، وكل المجتمعات في حاجة إلى نظام عقائدي، وقيم ومعارف من أجل بناء وإبقاء نظامها إلى غاية ظهور الإيديولوجيات الزمنية، لقد زودت الديانات المجتمعات ـ في كل مكان ـ بالأسس وأعطت الوظائف التي لا مفر من مصداقيتها.
إن مشكلة العلاقة بين الروحي والزمني تدمج كذلك فكرة التمثيل الديني عبر المؤسسات أي إدراك الأنظمة الدينية بالنسبة للسلطة لأن المجتمع المؤسس على قاعدة نظامها ديني بإمكانه أن يأخذ شكلين متصفين بجماعة أخلاقية، أو بمؤسسة بيروقراطية تراتبية تضفي على المعتقد صفة الرابط المؤسساتي للتابعين، يتضح لنا بأن المسار التاريخي لأوروبا تشده تناقضات كبيرة تتصارع فيها النظم وذلك باستبدال السلطة الموجودة معتمدة في ذلك على أنساق معينة تتفاعل فيها تيارات فكرية مولدة بذلك مفاهيم وتراث معرفي يحاول أن تحل القداسة الإلهامية أو المادية مجسدة في مواثيق تلزم أصحابها بتقمصها والتعامل على أساسها في التحكم بمجالها الاجتماعي لتضمن عملية دورانها بغية تطوير وتحويل النظم غير العادية إلى نظم عادية نتيجة التفاعل الاجتماعي الذي أعطى صورة محددة للشرعية تبعا للحقب والأزمنة وهذا انطلاقا من السلطة اللاهوتية، وتفاعل الفرد والجماعة مع المقدس مهما كان مجسدافي الله أو في المقدس أو الشيخ إلى أن ينتهي بتحكيم العقل والعقلانية.
النظام الديني والسلطة11 *
ليست السلطة السياسية شرا للإنسانية في نظر الإسلام بل قرار المولى من أجل العودة إلى الإيمان والمحافظة عليه وامتداد للقانون وهذه أول نقطة اختلاف بين الإسلام والمسيحية، وتحليل مسألة السلطة في الإسلام يقول “موريس ديفرجارMuris diverger”: ( الشرعية كما نقصد بها نحن هي مفهوم سوسيولوجي أساسا نسبي وجائز، لا توجد هناك شرعية بل هناك شرعيات تبعا للجماعات الاجتماعية وللحقب)، وهذا ماسنتناوله باختصار عبر المراحل التاريخية للحضارة الإسلامية وإبراز مواصفات كل حقبة مع نمط شرعيتها، واعتمادا على ما ورد في التعريف نلاحظ بأن الشرعية تشكل العنصر الأساسي لقبول السلطة، و( الشرعية هي المشكل المركزي لكل الأنظمة القانونية والسياسية)(12) وهنا نتساءل هل القواعد ومبدأ الشرعية تبدأ ـ كما تصوره البعض ـ مع الثورة الفرنسية كنسق له إمكانية إيجاد دولة القانون منتهيا بالتمييز بين المساواة والشرعية. فماكس فيبر يميز بين ثلاث فئات كبرى للشرعية تبعا لما تتضمنه:
ـ السلطة التقليدية: ترتكز على “العادات المقدسة وشرعيتها الأزلية والعادات المستأصلة في الإنسان للاحترام”
ـ الشرعية الكارزماتية: تتميز “بثقة كل إنسان في شخص ينفرد بمميزات إعجازية وبسمو الخاصيات المثالية التي تصنع القائد
ـ السلطة العقلانية: التي “تفرض بموجب المساواة وقانون الشرعية وكفاءة موضوعية مؤسسة على قواعد وضعت عقلانيا وبعبارة أخرى فإن السلطة مؤسسة على الطاعة وقيم علمية من واجبات مطابقة للقانون المدون13).
إن النظرية الشرعية عند فيبر “مفهوم، نموذج، ووظيفة” يرجع إلى عدة معايير مختلفة بها تمنح جوابا لمسألة كيف تبرر بقاء الهيمنة والعوامل المنتجة للمعتقد ولشرعية هذه الهيمنة التي ترتبط بها، ” أما بارسونز” فيرى بأن الشرعية نبعت من سؤال حول قبول أو رفض اجتماعي لمن يدعي الشرعية فالسلطة هي بقاء القيم والمعايير اجتماعيا تمتلك شرعية وفاعلية في الجماعات الاجتماعية تجعل من السلطة مقبولة وهذا دلالة على اعتبارات مدرسية مميزة تسمى بالوظيفية الجديدة.
وإذا كان “فرايد” في نموذجه يرتب الإسلام ترتيبه للمسيحية فنبوءته مدعية ومرسلة في نفس الوقت، غير أن فيبر يقول بأن [الظروف التاريخية] هي التي طورت الإسلام في اتجاه والمسيحية في اتجاه ثان وان هذا المعنى هو في نفس الوقت سياسي وديني كما أكده أليفيه كاري بقوله “ولد الإسلام خارج الإمبراطوريات والدول إذن أنشأ سلطة سياسية وعسكرية خاصة متبنيا الأنماط بسرعة بالإضافة إلى وجود هياكل بيزنطية وفارسية فللإسلام يعود الفضل في هذا الأصل المتمثل في عدم الفصل بين الدين والدولة فهو ديني وزمني بدون تمييز، باختصار تيوقراطي وأكد هذا”محمد أركون” الذي يرى بأن القرآن يفرض ترتيبا مؤسسا في أصله دون خلط أو تداخل بين الزمني والديني.
إن المدقق في أعماق البنية التاريخية للسلطة وما تتضمنه الشرعية في مسيرة المجتمعات الإسلامية يلاحظ بأنه بعد نهاية الخلافة مع الإمام علي( كرم الله وجهه) يبدو ظاهريا بأنه ليس هناك فصل بين الشرعيتين، أما في جوهر الأمور هناك شيء كثير يقال وأحسن دليل أن كل الثورات التي عرفتها المجتمعات الإسلامية أساسها المسجد أي بين الفقهاء والحكام أو بين الشرعية الدينية والشرعية الزمنية، إلا أن الخلط بين السياسي والديني يؤدي نحو تخفيض أو إذلال هذا الأخير في حدود التحركات الميكيافلية ويمكن أن نترجم ذلك على الشكل التالي:
لقد حاول فيبر تفسير التصرفات أو الأفعال عن طريق فهم المعاني. إلا أن التفسيرات الذاتية نادرا ما تتخطى الوصف المعقول للحالات الذاتية. وفي هذا الباب يقول براين تيرنر” ” (( أن التفسيرات التي يقدمها”فيبر” عمليا (كشيء مختلف عما يدعيه) ليست ذات طبيعة تعددية وان تفسيره ينطوي على عنصرحتمي قوي وبالذات في نظرته للإسلام مما يضعه في موضع قريب من نموذج ماركس التفسيري)14″، ولذا في نظر “فيبر” المتطلبات النظامية تعد عوامل ثابتة، وحكم على الإسلام بأنه يتبنى اتجاها شهوانيا خالصا، وأن القرآن يخفي الصراع بين المتطلبات الخلقية والدنيوية ولهذا لا يمكن أن تبرز أخلاق زهديه للسيطرة على العالم الإسلامي، وبهذا الاختفاء يفسر عدم ظهور الرأسمالية العقلانية في المجتمعات التي تسيطر عليها الثقافة الإسلامية”(15) موضحا ذلك أن العقلانية، والقانون الرسمي، والمدن المستقلة، وطبقة التجار المستقلة، والاستقرار السياسي لم تكن موجودة البتة في الإسلام وينتهي إلى الحكم التالي:” إنه لم يكن بالإمكان مع نظام الإقطاع الوقفي والبيروقراطية الإرثية التي كانت تتميزيهما الدولة العباسية، والحركات في الدولة العثمانية ظهور المتطلبات العقلانية الممهدة للرأسمالية، ولم تكن الظروف العسكرية والاقتصادية في المجتمع الإسلامي مناسبة لتطور الرأسمالية”(16) فإن النتيجة العامة في دراسته للإسلام، هي أن المجتمع الإسلامي يتميز بعلاقات سياسية اقتصادية وقانونية غير مستقرة مستبدة أو لاعقلانية بالمعنى الذي حدده فيبر نتيجة مقارنته بين الطابع العقلاني والمنظم للمجتمع الغربي وبين الأوضاع التعسفية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الإسلام. وهذا خطأ منهجي مع أن القائل بان الطريقة المثلى هي التي تبحث فيها أفكار معينة وعمليات اجتماعية محددة عن بعضها البعض في التاريخ. ولهذا نرى التعسف في حكم فيبر على مرحلتين مختلفتين بمقياس واحد، وكأن المجتمع الغربي هو المقياس السليم لكل المجتمعات، بل هذه التبعية في كل المجالات ولا يبقى للوضع الاجتماعي دوره ولا للخصوصيات الثقافية دور يذكر. وكيف يتناقض مع نفسه إذا اعتبرنا القياس سليما، فنظرته للزهد كشرط أساسي للرأسمالية العقلانية، لكننا نراه يقول في موقع آخر ((“لقد ولت روح الزهد الديني هاربة، ولكن الرأسمالية ما تزال منتصرة، فمنذ اعتمادها غلى أسس ميكانيكية فهي لم تعد في حاجة إلى تأييد الزهد الديني.
إن تسييس الديانة وتقديس السياسة أليس في ذلك مسخ للأهداف والمؤهلات المؤدية إلى: تدني الديني وتضخم السياسي ويعلل ذلك دوركايم بقوله” أن القانون والأخلاق والفكر العلمي ظلوا مفتوحين على الدين فكلما أخذ شكلا أو نمطا في المؤسسات كلما أصبح عاملا حضاريا وفعلا سياسيا..17)
لم يشكل علم السياسة في الفكر الإسلامي القديم علما مستقلا بالنسبة لعلوم الدين فكل الأسئلة مثل أسس الحكم وشرعيته، وأنواع الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم وحقوق المواطن” أن صح التعبير” كانت تعالج دائما في إطار الفقه والشريعة. أو أن موضوع السلطة كان محل اهتمام الشريعة، أما السلطة بمعنى الإمارة إي وجود نظام لممارسة السلطة فهو من طبائع وضروريات الاجتماع السابق على الشرائع) 18
فالسياسة لم تعرف أو لم تشكل مفهوما يعني ببساطة (الشيء أو الحدث السياسي)19، حسب المقريزي في كتابه السياسة، بل هناك من يرى بأنها كانت غير معروفة عند العرب إلى غاية دخول المغول في القرن XIII حيث صار للسياسة معنى مخالف لما كان يقصد به في الشريعة، فالسياسة ذكرت في آيات قرآنية بألفاظ (الحكم، الملك) الذي يقصد به السلطة، والمقريزي (1365-1441) يميز بين أمر الشرع والسياسة هذا التمييز يعتمد كأساس لكل قراءة سياسية ذات صبغة مادية.
إن التجربة المدنية (كنموذج مثالي للدولة المحمدية ) تتعلق بقوة الخطاب الديني ولذا عندما يتكلم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يتكلم باسم الله فهو كلام منزل فوق الإنسانية، ولذا يمكن أن نميز بين التجربة المحمدية وتجربة عيسي عليه السلام ففي الحالة الأولى وجد محمد صلى الله عليه وسلم في مجال جغرافي وإطار تاريخي حساس قابل لتأسيس دولة مدنية لا تتجاوز الإطار التنظيمي للقبيلة أما عيسي عليه السلام فقد وجد في وضعية كانت الإمبراطورية الرومانية جهازا سياسيا قائما بذاته والمعابد اليهودية ليست جهازا روحيا، ولذا لم يستطع عيسي عليه السلام أن يؤدي الدور السياسي في بداية نبوته، أما محمد فهو المبلغ المبشر النذير حسب التفسير القرآني ولم يصبح قائدا سياسيا إلا بعد الهجرة وسياسيا بمعنى إدارة العدل، وبالفعل لقد أبرم عقودا واتفاقيات ذات طابع سياسي مثل صلح الحديبية مع قريش، ولذا فهو أساسا نظام روحي ديني فالقرآن نداء ديني أخلاقي منذ بدء التشريع إلى غاية التنظيم الاقتصادي حيث أعطى المبادئ الأخلاقية من أجل خلق تشريع يعير عن احتياجات المجتمع في كل حقبة كما ترك للمؤسسين الاختيار في تحقيق الطرق وذلك تحت باب الشورى، والقرآن لم يتعرض لمسألة الدولة لكن قدم الخطوط العريضة لتوجيه الإنسان نحو العدل والصالح العام (20)
يقول “أيمن عبد الرسول ميريت:”إن الفكر العربي هش نظريا يحاول جاهدا الجمع بين العقل والنص، فيتغلب للنص حينا والعقل حينا آخر، ولا يحاول نقد النص والعقل معا، فالفرق بين العقل في المطلق والعقل في الإسلام يحتاج إلى مراجعة فالأول حر تماما ينتج نصه المختلف، أما الثاني تابع للوحي لا يتخطاه…والوعي متغير دائما، بحسب حاجاته ومعطياته، والاستخدام الأنفع للعقل والنص معا هو سر الفشل الذي منيت به حركات التنوير العربية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار21)، ويبدو إن هذا الطرح سليم إلا أنه يدفع بنا إلى تناول مواضيع كانت محل دراسة في التراث العربي بين المناطقة وأصحاب علم الكلام وكذا التيارات الفلسفية، بل كانت جوهر إشكالية الإيمان بين العقل والنقل وعلاقتها بالسلطة التي تتجسد في النص – إلى سلطة العقل في الفكر الإسلامي عبر مراحل تكونه وتطور أبعاده – التي تتجسد لدى البعض في القطيعة المعرفية والثورة واحتكاكهما بالمنظور الغربي المحض والذي يدعو إلى التطور خاصة “توماس كونTomas Koon “من مشكلة النص إلى ثورة العقل.
إلا أن الفكر الإسلامي وهو صاحب السلطة الدينية “لدى أهل السنة” وهو الذي ينتج سلطة النص المسيطر على الوعي الجمعي للمسلمين والحقيقة “( لا معنى لوجود وساطة دينية في غياب سلطة النص، لان السلطة الدينية هي التي تخلق النص كسلطة والسلطة السياسية هي التي تخلق السلطة الدينية بدورها)22 لا أن هناك قضية جوهرية تطرح في هذا المضمار، ألا وهي قضية تفكيك المعنى في الإسلام وهي قضية مهمة جدا من قضايا الفكر الديني، ولعل ما كتب عن الفرق الإسلامية بدءا من الملل والنحل،و انتهاء إلى إسلام بدون مذاهب أدى إلى التعددية الفكرية في أزهى عصور الإسلام مكونا بذلك تحررا فكريا، الأمر الذي أدى إلى التأويل وهو الأمر المستهجن من قبل النص القرآني. وأصبحت مشكلة التأويل تحتل مركز الصدارة في الخلافات بين الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة. وهنا نرى عبد الرسول يقول ” كان الاختلاف في التأويل هو أصل كل الاختلافات بين هذه الفرق وبعضها مما جعل التأويل من الأهمية كسلاح لإثبات المذاهب ودحضها، بذلك كان الإمام علي “كرم الله وجهه “على حق حين أدرك طبيعة النص وطبيعة الرجال الذين يفهمون النص حيث قال ” القران حمال أوجه، والقران بين دفتي المصحف لاينطق بلسان، وإنما ينطق به الرجال”(23). وإذا اتضح لنا بما ورد يمكن القول إن الأمور تتعلق أكثر بالمسألة الجوهرية التي نزل بها القران هي (اقرأ) آية العلم وبه تتحدد أبعاد المجتمع الإسلامي وتتوقف عليه غاية المجتمعات وأدوات تحقيقها بين العقل والعاطفة…
شرعية جديدة وضرورة الاتفاق
كانت هذه السلطة التزمت في بعض الأحيان صفة الاختزالية بحيث كرست في قبيلة واحدة، ونتساءل: أليس في هذا منعرجا لما ستكون عليه السلطة في المجتمعات الإسلامية فيما بعد؟ ألا يعد هذا مرجعية يستبدل فيها كل طالب للحكم ويؤسس على أساسها شرعية الاختزال السلطوي من ناحية وإعطاء مصداقية الثورات؟ وهناك من يرى بأنه بوفاة الإمام علي كرم الله وجهه واعتلاء معاوية الحكم وقعت السلطة في اللاشرعية24، ووضعت مبادئ جديدة لشرعية لها آلياتها ومواصفاتها التي تهيكلها وتضفي عليها طرق توظيفها، وكانت سلطة معاوية والصراع بينه وبين الخليفة الرابع فيما يوصف بالفتنة الكبرى مما يمكن اعتباره فتنة من الناحية الشرعية الدينية أما من الناحية الفكرية المعرفية فباستطاعتنا القول بأنها مرحلة تأريخ وتحديد العلاقة بين الدين والسياسة وهي المنبع الحقيقي لضبط علاقة السياسي بالديني وتحديد مجالات تطبيقها وصلاحية لكل واحد منها، بمفهومنا الحالي (تنظيم علاقة السلطة الدينية بالسلطة الزمنية ولا نقول بفصلها لأن في هذا الفصل إن صح التعبير زوال معالم حضارة بمفاهيمها وخصوصياتها إلا أن ضوابط مجالات تخصص كل سلطة تفرض ذلك، ولهذا نستطرد بعض الآراء الفكرية لحركية التيارات الثقافية القديمة وتتبعها في أشكالها ومظاهرها تبعا لمسيرة تاريخ المجتمعات العربية الإسلامية وتفاعل أنماطها الفكرية مع واقعها التضامني الاجتماعي لتحدد بذلك المكانة الشرعية للعلم والعقل داخل البنية السياسية العامة، وكذا مدى ارتباط النظرية بالممارسة، وتبدأ بممارسة السلطة ثم انتقالها وشرعية وضعها، فالسلطة25في مجملها حسب ما يفهم من المصادر التاريخية انتقلت من حكم ثيوقراطي إلى سلطة الخليفة إلى الأسرة المالكة في سرد بعض آراء المفكرين المسلمين في شأن الحاكم، يقول الماوردي(26) ((مؤسسة الإمامة “الخلافة” لها حق الوجود حتى تقوم مقام النبوة من أجل حماية الدين وإدارة المصالح الدنيوية)) (27) أما ابن خلدون فيعرف الخليفة ((كمؤسسة لحماية الدين وتسيير حاجات العالم الدنيوي، وبهذا تصلح المؤسسة الخليفة أن تنوب على المشروع في حالة أين هو يعمل على حماية الإيمان أو العقيدة وتسيير العالم)) (28، كما يفضل ابن خلدون أن تكون للسلطة مرجعية معايير سياسية عقلانية نابغة من المعتقد ويرفض السلطة الملكية المؤسسة على الهيمنة والقوة حيث يقول: ((ضروري للسلطة أن تعود إلى المعايير السياسية المقبولة من طرف الجماهير الذين يخضعون لقوانينها))، وعند النظر إلى ما تقدم نلاحظ أن الموضوع أخذ حقه في التراث الإسلامي رغم أننا لم نلم بكل جوانبه الكاملة وقد كان التركيز دائما على استعمال العقل بالإضافة إلى المعارض والمؤيد لنوع السلطات فهناك من يرى بأن الإسلام ينطوي على فلسفة الطاعة أو المداهنة ومقاومة السلطة السياسية، وهذا ما دار من صراع بين الفقهاء والحكام29، وهناك من يرى بأن السياسة هي سبب سقوط الإنسان، فالدين يفرض على السياسة تمرينا محدودا مضبوطا بمجال الحرية التي أوجدتها والعكس مما يفترض ضرورة علاقة الدين بالسياسة.
أما المقاربات الحديثة فهي متنوعة من المتحاملين على الإسلام دون موضوعية ولا منهجية، وملخص قولهم: الإسلام هو السبب الرئيسي في الانحطاط، وإذا كانت هذه الدول استبدادية فلأنها منحدرة من الدين الإسلامي، لكن في حقيقة الأمر هذا اعتراف ضمني بأن هذه الحضارة شيدت على عاتق الإسلام وانحطاطها يعود إلى أفرادها لأنهم لم يفهموا الإسلام مثلما فهمه الأوائل الذين شيدوا هذه الحضارة، ومن هنا فنقد للإسلام غير نقد مؤسساته ودولته، فمثلا bon voltaire Volney يقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان طموحا واستعمل الدين لصالح مشاريع الهيمنة المدنية الاجتماعية ((فالقرآن نسيج خطابي متناقض وعمومي وأخلاقي مرتذل وخطير ونتمنى من المجتمعات الإسلامية أن تتخلص من ضغط الدين والفكر الإسلامي وهو الطريق الوحيد من أجل نهضة حقيقة لهذه الشعوب)30، فلم تقدم شيئا للحضارة سوى نقل الموروث الإغريقي بل هو آلة ترجمة فقط، غير أن نظرتهم جميعا في القرن 18 ترى الإسلام أكثر أرثوذكسية وأكثر استعمالا للعقل، على عكس الفلسفة العقلانية في أوربا التي جدت مقاومة شديدة من طرف الكنيسة، هذا التحامل غير المبرر لا يتماشى وادعاء العلم والموضوعية، فالجميع يعلم بأن الإسلام شيد حضارة كانت سندا قويا لحضارة اليوم وهذا كاف لتبرير عقلانية الدين من ناحية والزخم المعرفي من ناحية أخرى، ونستنتج من هذا بأن العيب يكمن في الأنظمة التي تدعي الإسلام والأشخاص وليس في ماهية الدين.
أما الرواد الجدد فإنهم يرون الإسلام دينا31 و سياسة ولديهم خلط بين الدين والسياسية، وانقسم المفكرون العرب إلى: تقليديين يرون في الدين عودة إلى النمط التنظيمي السياسي و الخلافة هي البديل للأزمة التي عرفها العالم الإسلامي و الخليفة هو الذي يحافظ على وحدة الأمة، أما المصلحون فحركتهم أسست على دعم المصالحة بين التحديث والأصالة، لكن هذا الإصلاح أجهض ومحاولاته النظرية والعملية فشلت، فالأفغاني ورشيد رضا وغيرهم أكدوا على إيجاد الخليفة ووحدة الأمة إلا أن مقاربتهم لم تحل عمق المشكلة لأنهم أهملوا تحليل أسس الأنظمة الديمقراطية وقواعد الشرعية واكتفوا بتعليل تقدم الغرب وفشل الدول الإسلامية إلى قصور الجوانب العلمية الاقتصادية والعسكرية، ولم يطرحوا أسئلة جذرية حول المؤسسات السياسية للغرب وما هي الطرق المستعملة في التسيير ومكانة الفرد، غير أننا لا ننكر بأن صدى الإصلاح أدى إلى غرس روح الجهاد والمناداة بالتحرر والمواجهة مع المستعمر، أما معارضو الإصلاح فقد اقتنعوا بنظرة الغرب وانتهجوا إستراتيجية القطيعة ودعوا إلى ضرورة فصل الدين عن الدولة، وهنا طرحت إشكالية حول معرفة الإسلام هل هو دين فقط أم هو في نفس الوقت عقيدة ودين ودولة…؟. وهو إشكال لم يطرح من القدماء ولا من أتباعهم، لكن الفقهاء المحدثين (32**)قدموا شرطا أساسيا في الشرعية هو تطبيق الشريعة وحماية الدين والأمة دون العودة إلى الخلافة، وفشل كذلك من ينادون بفصل الدين عن الدولة في حل مشكلة الاستبداد وتذليل المصاعب وإيجاد طريقة مثلى لنشر الحداثة، ويطرح عبد الرؤوف بولعابي سؤاله في هذا الشأن: كيف نحرر الفكر السياسي الإسلامي من جموده دون صدم الوعي الجمعي الإسلامي ودون تعارض مع القيم الأساسية الإنسانية.؟ وهذا يتطلب وضع وإيضاح نواة القيم المشتركة التي تسمح بتحقيق الاتصال الجمعي بين الفلسفة الإغريقية والفلسفة الإسلامية العربية بطريقة تتجاوز علاقات المواجهة والهيمنة التي كانت صفة تاريخية بين الغرب والإسلام، إذ يقول بأنه يمكننا –دون عقدة- إحداث علاقة جدلية بين الإسلام والعصرنة من جهة وبين الإسلام العتيق التقليدي من جهة أخرى، فالتجربة الإسلامية تاريخيا نقطة اتصال بين الحضارتين، ونواة القيم المشتركة تتكون من ثالوث يوجد عند المفكرين الوطنيين للحضارات الثلاث وهو نابع من مفكرين عقلانيين، فعند الإغريق فلسفة أرسطو، وعند المسلمين الفلسفة السياسية لابن رشد، وعند المسيحيين في القرون الوسطى فلسفة سانت توماس الأكويني.
إلا أننا نكتفي بهذا الحد من الإشارة للخلافة لأن هذا بحد ذاته يشكل موضوعا لايتسنى لنا في هذه العجالة أن نتعرض لكل ما قيل فيه من مواضيع متشعبة مثل: أساس السلطة وقيام الدولة وعلاقتها بالشرعية وهنا نجد الفلاسفة والمؤرخين أثروا هذا الجانب فانظر على سبيل المثال ابن رشد في أصول الفقه وكذلك التهافت وفي بقية كتبه القيمة وغيره ممن نادوا ببقاء الاجتهاد مفتوحا مع العودة إلى الأصول ونبذ التقليد وهناك من يحمل القضاة والفقهاء التقليديين مسؤولية غلق باب الاجتهاد وظهور فقه عقيم لا يحتل فيه العقل المكانة الكبرى.
وتعتبر دراسة الدولة والدين من أهم القضايا التي طرحها الخطاب الإسلامي العربي المعاصر ممثلة في تجديد (الأسس النظرية للسياسية المدنية بما تنطوي عليه من إعادة بناء القيم المرجعية وإعادة تأسيس الدولة التي تقع على عاتقها مهام الجماعة أو الجماعات العربية التي انفصلت عن السلطة أي تقرير الحكم ومبادئه ومقوماته… وكل ما يذكر من صراع حول القضايا الوطنية والاستعمار والوحدة الإسلامية والاستبداد والحرية وتأصيلها على أرض الواقع هو صدى للفكر الغربي ولم يأخذ منحنى داخليا ولم يكن محكا للواقع، بحيث شكلت هذه العلاقة محورا تركزت عليه المناظرات السياسية العربية قديما وحديثا ويستفسر بولعابي عن أصولها التاريخية وأسباب النزاعات بينهما فيقول: إن الواقع المسيطر على قضية الشرعية في العالم العربي لا يزال بحق تحت رحمة مقدس الخلافة وما يرتبط به من شرعية تعود بنا إلى الأصول الأولى في فكر الخلافة أو ما يمكن أن يطلق عليه اسم الموروث السلطوي تحت لواء الرمز السياسي لجماعة رسخت صورتها في الوعي بل تهيمن على الكيان المادي والروحي لكل عربي مسلم وما خالف ذلك يصبح مدنيا، وهذا الصراع أفرز فراغا حقيقيا في مجتمعاتنا ترتبت عنه معاناة جلية لازمته إلى يومنا هذا، فارتاب بين الانفصال والقطيعة أو العودة إلى الماضي بزاد هزيل وتراكم معرفي مشوه وهو ما أوجب على الكاتب طرح المسائل في إطارها التاريخي لأنه فهمها فهما موضوعيا علميا لا يتحقق إلا إذا نظرنا إليها في تاريخها وربطناها بالمشاكل والتناقضات التي يعيشها الواقع الاجتماعي السياسي.
فالتاريخ لا يولد من الفكرة ولكن العكس هو الصحيح فالفكرة هي بنت التاريخ والواقع المتغير، مما يتفق وصيرورة التاريخ ونشوء الوعي الاجتماعي ولا يتوقف فهمها دون العوامل الداخلية الفاعلة في تحديدها وتوظيفها بل الواقع الاجتماعي والتجربة التاريخية هما مستودع مفاتيح هذا الوعي كل هذا لا يدل على أن الباحث ملتزم بالأدبيات الماركسية بل كما سيتضح أكثر بأنه أقرب إلى المنهج الفيبري الذي يعتمد على الشرح والتحليل والأخذ بتعدد المسببات بل يرى بأن ((فهم الحركات الدينية يستدعي موضعها من التاريخ بما هو دينامكية باعثة على تغيير المفاهيم وتبدل قيم الجماعات ومطالبها وتوازناتها ومصالحها)33، بل هي الباعث الحقيقي لتقييم جذري للتراث الديني والعقلي وتوزيعه حسب حاجات الصراع القائم وتوظيفه على ضوء الأهداف والأغراض السياسية الجديدة، فهي تتغذى من الدين أكثر ما تنبع منه أو تغذيه ولهذا ترى الأستاذة زهيه حويرو34 أن العودة إلى حاضر التيارات الفكرية السياسية كشفت الدوافع العميقة التي جعلت المواقف من هذه المسألة تتوزع بين تيار علماني يعتبر الفصل بين الدين والدولة أساس كل إصلاح سياسي ومنطلق كل تحديث. من أمثال السيد زغلول وطه حسين وغيرهم مما أسفر عن بروز رؤيتين متعارضتين في موضوع الدولة والشرعية السياسية، فالأولى دينية تقليدية والثانية حديثة مستمدة من أفكار القومية المنتصرة في الغرب وهذه نتيجة انهيار التوازن الداخلي، ((إن نشوء الفكر القومي العربي المرتبط بمعتقد بناء الدولة الحديثة لا يتم في إطار التمسك بالمرجعية الدينية العقدية، بل تطلبت تنمية الوعي القومي في مقابل الوعي الديني)) والثاني إسلامي أصولي يعتبر الربط بينهما والعودة إلى إحياء النموذج الإسلامي من الحكم وتطبيق الشريعة في تنظيم السياسة والمجتمع السبيل إلى إخراج المسلمين من وضع الاستلاب والتهميش الذي يعيشونه.
يتغذى الأول من الحقوق مما تنطوي عليه فكرة الخلافة وما يعكسه من تكريس السلطة الشخصية والاستبداد وغياب الرؤية الدستورية، والثاني كما يراه الأستاذ (غليون) يتغذى عكس ذلك من الخوف مما يشكله التخلي عن مفهوم الخلافة والإمامة العظمى من خطر على ركائز الإسلام، وهذا ما يثمنه (عبد الحميد الشرقي) حيث يقول: إن المتتبع للدراسات النقدية العربية دأبت في مجملها على اعتبار الإنتاج الديني ملازما لرفض الحداثة، أي أنها تنظر إلى ذلك الإنتاج كنوع من المنظومة المغلقة التي لا تفتأ تكرر ذاتها من فرط زهوها بقناعاتها ووثوقها بكمالها إلا أنها لم تنفك في الحقيقة عن أن تفقد انسجامها القديم تحت وطأة آثار الحداثة التي أدت إلى تفجرها وانشطارها في اتجاهات متضاربة بتضارب المنازع وتعدد المواقف وتعارض المصالح.
فإذا تبصرنا لهذا فقط برؤية نقدية ألا يمكن أن نعتبر ذلك عنصر ثراء وعامل ديناميكية، ويرى عبد الحميد الشرقي تثمينا لكلام الأستاذ غليون بقوله: ((إن هؤلاء أنصار أو منظري”التيار الإسلامي” يعتبرون أنفسهم “حراس الهيكل” الموكلين بحفظ ما بلغهم عن أسلافهم وتبليغه كما هو إلى أخلافهم وليس في الأمر أدنى غرابة فهذه القاعدة تنطبق على رجال الدين في سائر الديانات التوحيدية منها وغير التوحيدية وهي المبررة في النهاية لوجودهم ومبعث السلطة المعنوية التي يحظون بها ويجنون ثمارها فلا ينتظر منهم أن يقطعوا العصب الذي عليه يجلسون))( 35). إلا أن ما يؤاخذ على تلك الرؤية هو كونها توجه نقدها لما فات فنتج عن هذا تيار جديد ساعد مع بروز عوامل متعددة من بينها التغيرات الكبرى وتفاقم وطأة الاحتلال الغربي، وكذا الحربين العالميتين كل هذا أدى إلى إيجاد تصور قومي قام على زرع الوعي القومي التحرري الباعث للاستقلال وبناء شخصية مميزة ولهذا تحول الوعي الثقافي من موروث قديم إسلامي محنط إلى موروث قومي وطني يجمع بين التقليد والتحديث أي دولة المصالحة بين الدين والسياسة والتراث والحداثة.
((غير أن هذا التحالف هو ظرفي وليد زمن النخبة كما سبق الذكر إذ له عوامل خارجية ليست لها أسس معرفية قوية باستطاعتها إجراء عملية جراحية حقيقية تشرح فيها حقائق الموروث التاريخي تحت رؤية علمية ثاقبة تنتقي منه الصالح وتصلح فيه الاعوجاج وتضرب فيه مفاهيم جديدة لتؤسس لعطاء معرفي قوي يمكن أن تكون قاعدة قوية تضرب فيها أسس دولة حديثة تجمع فيها معالم الصواب تحت راية العقل والدين))36، وهذا كاف للرد على الباحثة المغربية في عرض الأستاذ لما تناوله في الممارسة السياسية التاريخية بحيث ذهبت إلى حد القول: ((ذهب الأستاذ غليون مذهب أهل “السنة والحديث” في التمييز خلال الحقبة التي امتدت من عصر النبوة إلى سقوط السلطنة العثمانية بمراحل “النبوة” و”الخلافة” و”الملك العضوض ” وهو التمييز الذي دعا إليه ابن خلدون وفي إطار هذا التمييز أثبت أن مشكلة العلاقة بين الدين والدولة لم تطرح خلال فترة النبوة وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه الشيخ عبد الرازق عندما بين أنه لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نظام قضائي ولا نظام سياسي فاستنتج تبعا لذلك أن النبي لم يكن حاكما وأن الإسلام شرع تبليغي لا تنفيذي ولذلك فإن الرسول لم يكن له إلا زعامة دينية انتهت بوفاته، وهذا هو وجه الصواب لأن الرسول لم يكن في حاجة إلى سلطة سياسية لأن الدعوة دينية والصراع ديني بين الوثنية والتوحيد والقرآن منزل لا يحتاج إلى استشارة، فالزعامة الدينية أقوى من الزعامة السياسية، لأن هذه الأخيرة تعمل على تقرير أمور الحياة الدنيوية، وهو ما طبقه الرسول في استشارته للصحابة عندما تعلق الأمر بذلك فيقول: ما أنا إلا بشر مثلكم، وأنتم أدرى بأمور دنياكم.
فنجد هناك نصا واحدا وتأويلات متعددة، على سبيل المثال: بين الفكر الثوري الخارجي والمعارضة السياسية، وبين فقهاء البلاط والمعتدلين، ولكل قراءة مبرراتها، مثلا: شباب الصحوة لا يرضون بأقل الإيمان ولا بعدم الاستطاعة، لديهم أقوى الإيمان تغيير المنكر باليد، أما أصحاب البلاط فيرون مراتب تغير المنكر ثلاثا: أولا: طبقة الحكام (ولاة الأمور) وهم أصحاب حق تغيير المنكر باليد، ثانيا: طبقة الفقهاء والخطباء والوعاظ وهم أصحاب حق تغيير المنكر باللسان، ثالثا: الشعب والعامة، وهم أضعف الإيمان، الذين يستنكرون بالقلب، أما التأويل [الإرهابي] فهم من أنصار الخروج عن الحاكم الجائر، وهو ولي الأمر: ” من رأى منكم منكرا فليغيره بيده..” موجه لكل مسلم، ولفظة منكم تفيد الشمول، و(فليغيره بيده) أي الهاء عائدة على الذي يرى المنكر، والفاء حرف تعقيب وسرعة، أي لا تضع جدارا مبنيا بين رؤية المنكر وسرعة تغييره باليد ” المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف”، ثم التأويل الإرجائي هدفه إيقاف المنكر ولا يدعو إلى إقامة الحد37
ووفق باحثين كان بناء دولة أمرا غير مفكر فيه لدى المسلمين عندما طرحت عليهم قضية الخلافة ((عند وفاة الرسول لم يخطر ببال أحد أنه يبني دولة أو يرث سلطانا بأي معنى من المعاني))، ويرى آخرون في المقابل أن المسلمين فهموا من الخلافة أنها تنشر الدعوة لا لرعاية مصالح الدنيا، أي خلافة لها جوهرها الجهاد في سبيل الله لا بناء الدولة ولا تنظيم شؤونها، وهذا الموقف هو الذي جعله ينفي الدوافع السياسية السلطوية عن الخلاف الذي نشأ إثر وفاة الرسول حول الخلافة، فهذا الصراع كان على السلطة الدينية وداخل إطار الدين نفسه(38)ولهذا ترى (زهيه حويرو) بأن الأستاذ (غليون) ناقض نفسه عندما بين أن المسلمين كانوا يدركون أن خلافة الرسول لا يمكن أن تكون خلافته في أمور الدين ما دام الدين قد اكتمل عندما انقطع الوحي بوفاة الرسول كما كانوا واعين بأن خلافته كانت تعني في المقام الأول خلافته في إدارة شؤون المسلمين دون أن ينفي ذلك مواصلة المشروع الذي بدأه والمتمثل في بناء دولة التوحيد وتعميمها وهل يعني هذا شيئا غير بناء دولة؟، أن هذا الفهم الذي ذهب إليه الصحابة الذين جمعتهم سقيفة بني ساعده يؤكد أن الخلافة لم تكن أمرا سياسيا ولم تكن هادفة إلى بناء أمة التوحيد إلا بمقدار رغبتها في بناء دولة التوحيد كذلك، ولذلك كان الصراع حولها مدفوعا بعوامل سياسية سلطوية ناشئة عن إدراك المسلمين أن الوظيفة النبوية والوظيفة الخلافية معا تؤلفان بين الدنيوي والقدسي ويقوم سلطانهما على كلام الله مثلما يرتكز على التوجيه الفعلي للأمة وعلى إدارة شؤونهما وأنها وظيفة قيادية سياسية ستلتزم خلقا بذلك، ويرى (هشام جعيط) أن تسمية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ذاتها برنامج كامل لتواصل السلطة النبوية ليس في جانبها ما فوق البشري المرتبط بالوحي فحسب بل في جانبها القابل للتوريث والمرتبط في جوهره بالسلطة الزمنية. فالخليفة هو رأس الأمة الإسلامية وقد ورث القيادة “الإمارة” عن النبي[صلى الله عليه وسلم]39.
فكل ما يتعلق بتنظيم الحياة الحضرية والعسكرية والسياسية هو متروك للعقل والتجربة، لكل فن قواعده وهذا ابن حنبل يثبت حدود شرعية وكفاءة الخليفة فهو لا يطاع إلا فيما تمنحه سلطة أجهزة الدولة، أما المعايير الدينية فهي من اختصاص أو مسؤولية الأمة الموجهة والمستنيرة بالعلماء بعيدا عن السلطة كما هي معرفة في الرأي العام.
فالخليفة من واجبه حماية وتطبيق القانون الديني لكن ليس له الحق في تحديده وفرض محتواه، فالعصيان يكون على مستوى الأيديولوجية اللاهوتية لكن في غير مبادئ الخلافة نفسها وهذه القاعدة تترجم في الواقع خضوع السلطة السياسية للعلماء لكن في الواقع القانوني هناك فصل واضح بين السلطتين، أما التطور التاريخي فيتجه نحو تشكيل محيط سياسي بعيد عن المجال الديني، فالدولة ابتداء من بني أمية برزت فيها سياسة في رحاب أيديولوجية امتدت للهيمنة على الرؤية الدينية والذي وسع تدريجيا مجال نشاطه الديني مع الدولة العباسية فالثقافة الدنيوية والمؤسسات واحتفالات الديوان والحياة الاقتصادية يعود الفضل فيها إلى عادات الساسانيين والفكر الإغريقي وهذه العادات موجودة حية إلى يومنا هذا في الشرق الأوسط القديم مع التزامه بتعاليم الدين والقرآن(40).
كانت تلك علاقة سلطة العلماء بالسلطة السياسية باستثناء الصوفيين الذين نبذوا هذا المجتمع وما يصحب من ماديات فالدولة في نظرهم صبغت الدين بصبغة دنيوية مع محافظتها عليه كمبدأ الشرعية، إن تكاثر الملل والحركات الاجتماعية السياسية تعكس أو تبرز إيديولوجية الشروط الاقتصادية والمصالح السياسية وحسب Weber عندما يظهر شكل للدين متوافق مع بعض الفئات الاجتماعية فإن شروط الانتماء تمنحه حدا أقصى من فرص البقاء في صراعه مع أشكال أقل توافقا.
ويرى الأستاذ غليون: ( أن التعصب الديني الذي تتهم به الحركات الدينية والاستلاب الأجنبي الذي يقدمه البعض الآخر لتفسير نشوء الفكر العلماني لا يستطيع أن يقدم تفسيرا مقبولا لما تشهده المجتمعات العربية من تحولات جديدة وعميقة سياسية واجتماعية)، غير أن طرح غليون أو إشكالية الدولة والدين تعتبر من أهم الطروحات في الوقت الحالي بحيث تناولت جوهر القضايا التي تعتبر قاعدة بناء المجتمعات وتشخيص حقيقي تبعا لمراحل تكونها إلى غاية ما وصلت إليه في منعرجها الأخير فهو عمل تشريحي توخى الموضوعية بل نظرة ناقد متعال على التأثيرات الأيديولوجية، ويستحق الوصف الذي يوصف به المثقف الحقيقي من طرف الجابري: ( اعتقد أن دور المثقف في المجتمع العربي قديما وحديثا دور سياسي في جوهره أما في عصرنا فإنه لم يعد ممكنا الفصل بين الثقافة والسياسة خصوصا في وضعنا الراهن الذي يتميز بغياب الأيديولوجية..)41.
ومجمل القول أنه يمكننا حصر بعض القضايا وليس كلها تبعا للطروحات السابقة القائلة بأن الصراع التاريخي الذي لا يزال يشكل ثقلا على مجتمعاتنا إلى هذا اليوم هو صراع بدأ بما يعرف بالفتنة الكبرى وبداية الحكم الأموي الذي فصل بين الدين والدولة أو السلطة الزمنية والسلطة الدينية عمليا فصلا غير معلن، ومما يقره الجميع أن السلطة الزمنية تتصل بالدينية لتأخذ منها، بالإضافة إلى اختزال السلطان السلطة في عشيرته مما مهد لتشكيل طبقي عرقي سلطوي فيما بعد ولهذا أبعدت صفة المواطنة إن صح تسميتها بذلك، وعلى الرغم من أن الإسلام كما يقول الأستاذ Harien بجامعة Bonn : (..إن روح الإسلام رحبة وبدون حدود إلا مع الفكر الإلحادي(42)* فقد استوعب الفكر الإسلامي كل الأفكار الآتية من الشعوب المجاورة وصقلها بتوجهاته الخاصة إلا أنه من الملاحظ أن الصراع في مجال الحقوق أخذ في كل حقبة صورة تمنح لكل العلماء فرصة تتاح أن ينتقد الواحد الآخر بوصف كل منهم الآخر بالبدعة على الرغم من وحدة الهدف مما زاد في سعة الهوة بين النظري والتطبيقي وهي الهوة التي نشأت في الأصل من غلق باب الاجتهاد.
وبالرجوع إلى السؤال الذي انطلقنا منه لماذا هذا الطرح وماذا يفيد؟ نجيب بأن الحياة في المجتمعات تتواصل ولا توجد قطيعة حقيقية فيها، ومشاكل الفكر اليوم تحتاج إلى نظرة شاملة تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، بمعنى يجب عقلنة الماضي حتى يصبح مفهوما ومدركا، وعندها يمكن أن تنطلق منه كي نحل مشاكل الحاضر بصفة أوضح ونستشف المستقبل، وإذا عدنا إلى تاريخ أوربا والتصادم الفكري الذي عرفته في هذا المجال واستفاض فيه الفكر فيما يعرف بفلسفة التنوير التي نادت بعتق السياسية من قبضة الدين نجد ذلك التصادم أنتج تراثا معرفيا قويا أفرز مجالات معرفية مترابطة في ما بينها ومتصادمة في البعض الآخر، مما أدى إلى ميلاد عدة مفاهيم فكرية سياسية دينية ضبطت حدود المعرفة باصمةً فيها بخصوصيات كل واحده منها، مثل اللائكية والديمقراطية الدينية…الخ.
وهنا نتساءل: ألا يحق لنا نحن الشعوب العربية الإسلامية المطالبة بعتق الدين من يد الساسة وقد علمنا بأن السياسة الآن لم تعد فنا ولا علما؟ وهذا المطلب جوهري في حد ذاته لان مسار المجتمع الغربي كما رأينا عبارة عن صراع وتطاحن لم نستفد منه كثيرا بل حدث تصدع فكريا واجتماعيا كاد يأتي على الأخضر واليابس لكن المبررات الحقيقية تكمن في أننا لم نستغل الظروف ولم نقتد بل لم نحسن الانتقاء فمن الجانب الديني لا نريد الفصل كما ادعى بعض المفكرين الذين أرادوا تقمص ثقافة الغرب ففشلوا وهذا لسبب بسيط وهو مهما حاولنا الاستيراد لن نستطيع استيراد مجتمع بل يجب البحث في دواعي تقدم الغير مع مراعاة الزمن وهو العنصر الأساسي في تمييز الأمم بالإضافة إلى العلم والتعلم، فالأمة الجاهلة عبارة عن كيان بلا روح ولن تستطع أية نخبة أن تعطي ثمارها أن لم تعتن بهذا الجانب فالنخبة هي ثمرة لا تعطي أكلها في أرض جرداء ولذا يمكن القول بان الرجل العربي المسلم هو مشلول النصف إذا لم يعتن برفع قدرات المرأة وهي نصفه الثاني وتمكينها من العلم حني تستطيع الوقوف إلى جانبه وبغير هذا لن يحقق أي مبتغى، وعلى النخبة مهما كانت مواصفاتها أن تحرر المتغير الرأسي في هذه العملية ألا وهو الفرد، فالمجتمعات العربية توصف الآن بأنها مجتمعات ذات قطبين يتدحرج بينهما: الماضي البعيد الذي لم ينقح وتراكمت عليه الشوائب ومستقبل مجهول وحاضر مُغيب مما مكن الماضي أن يأتي على الاثنين معا ويخرجنا من دائرة السباق الحضاري، ولعل هذا لا يحد من عزيمة أمة تملك ما لا تملكه غيرها من مقومات البقاء والظهور أن أحسنت استغلالها، ولا يتم هذا إلا إذا كان بمقدورنا أن نحقق هذا التواصل بين الأزمنة خاصة وأننا نعلم عيوبنا، متسائلين –لنضبط علاقتنا مع الزمن -: هل السياسة مريضة من الزمن أم العكس الزمن مريض من السياسة ؟
ثم ما هو المشكل السوسيولوجي المهم الذي يتستر وراء العلاقة بين الدين والسياسة الشرعية؟ هناك مجموعة قيم فيها علاقة ثقة والتزام يضفيه المواطن في علاقته مع النظام السلطوي الحاكم. فالشرعية هي مرحلة اجتماعية تسمح للنظام السياسي الموجود بالحصول على إجماع وصيرورة تفترض نشاطا (إقناعا) من الأعلى (من طرف الذي بيده الحكم) وقوانين مشرعة في القاعدة وهذا يؤسس قانون الحكم، ونستنتج من كل هذا بأن المراحل التاريخية التي مرت بها المجتمعات العربية الإسلامية هي مراحل مد وجزر، كان الدين فيها عاملا رئيسيا، فتباينت قوته من آمر إلى سند ومن باسط النفوذ إلى نسق تابع فإذا استثنينا حقبة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم ) والخلفاء الراشدين نقول إن السلطة هي سلطة ظاهرها ديني وباطنها دنيوي وهذا لا يدل على وجود فصل بالمعنى الغربي ولا دولة دينية بل هناك تجانس في المهام فرضته أمور واقعية أي ثقل الواقع وما يفرضه.
الأمر في الحقيقة لا يتعلق بمدلول الدولة هل لها طابع سياسي أو ديني بقدر ما إذا كانت لها نتائج ترتب على الوضعية الحالية فالمفاهيم حبيسة الوعي الاجتماعي والإطار التاريخي فمصطلح الدولة والأمة يتفاعلان مع كل حقبة لأنهما مرتبطان وكما يقول فيبر أن كل فعل يتولد عليه معنى الشرح والفهم، وهنا نطرح سؤالا جوهريا ألا يبدو هذا سابقا لزمانه لأن القاعدة العريضة أو الشرائح الاجتماعية الواسعة في مجتمعنا لها القدرة على تحمل عبء هذا العطاء وتفهمه وتوظيفه؟ بل يمكن القول بأن هذا يساعد على تمادي السياسي وتورط الفقيه إلى أن تنفجر قوى التناقض الكامنة في الفكرة الوطنية، وكل ما سبق ينتهي بنا إلى طرح سؤال يتضمن إشكالية تحتاج إلى عناية خاصة ويستوحي إطارا معرفيا جديدا وخاصا مرتبطا بالمجال والزمان انعكس على واقع الأمة العربية على الرغم من اختلاف نمط التفكير والبعد المعرفي لكل حضارة، فنحن اليوم حسب المعايشة اليومية واستقراء واقع الأمة العربية نتساءل هل بإمكاننا أن ننادي أو نرفع شعار عتق الدين من يد الساسة عكس ما ورد في الفكر الغربي، وما أفرزه واقعهم الجيوسياسي ديني؟
إلا أن السؤال الذي نجعله محصلة يتمثل في التساؤل عن مدعى الدين الذي يمد يده إلى السياسة، ألا يعني سلوكه هذا أنه فقير في الدين والسياسة؟ وعلى المنوال هذا يتبادر سؤال حول الرجل الذي يدعي التضلع في السياسة وهو يهرع إلى استعمال الدين ألا يدل ذلك عن عجزه الفاضح في فهمه السياسة وحسن استعمالها ؟
وفي جميع الأحوال إن كل ما هو فردي حين يتحول إلى اجتماعي يصبح “سياسيا” والديني نفسه حين يكف عن أن يكون”للإنسان في خاصة نفسه” ويصبح شأنا للجماعة لابد إن يصبح سياسيا، وكل فهم للديني يأخذ بمبدأ” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “يحول الديني بالضرورة وبالماهية إلى “سياسي “، وتتولد له بعد ذلك قضاياه ومسائلة43، ويقول “الماوردي”(الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا)44 ، ولقد عبر الخليفة المأمون تعبيرا دقيقا عن منطق الدولة وطبعها حين قال إن الملوك تتحمل كل شيء إلا ثلاثة أشياء: (القدح في الملك، وإفشاء السر، والتعرض للحرم)45 ، وغني عن القول أن الدولة التي يعنيها المأمون هي الدولة “الموتوقراطية” حيث الأمر لا يعرف إلا السمع والطاعة ولا يقبل المنازعة أو المنافسة أو الرد وهي الشكل الذي جرت عليه الدول الإسلامية التاريخية.
ويقول j.Freund لاشك أنه ما من صراع بين الأفكار إلا وهو يخفي صراعا بين الأشخاص46،والحقيقة هي إن الصراع بين أهل الدين وبين أهل الدولة في الإسلام كان أحد الأشكال الكبرى للصراع السياسي، والعلاقة بين القوة الدينية وبين الدولة ما هي إلا قوة سياسية يمكن أن توجزها خير إيجاز هاتان العبارتان ” الطاعة القسرية أو العصيان السلبي ” والحقيقة هي أنه لم توجد أبدا ولن توجد آبدا السلطة الواثقة ثقة مطلقة من إنها ستظل مطاعة على الدوام طاعة تامة فقد عرفت ذلك كل السلطات، وهي تعرف أن التمرد ثاو حتى في أكثر أشكال الطاعة انقيادا، وأنه يمكن أن يتفجر بين يوم وآخر، تحت ظروف غير متوقعة، وقد أدركت جميع السلطات أنها هشة وذلك لما تجد من أنها مضطرة لاستخدام القوة لغرضها، وأن السلطة الوحيدة التي لا تخاف هي تلك التي تتولد من الحب، وتكون مطاعة في مناخ زاهر من الحرية.
إن المنطق الذي يتحكم في جدلية الديني والسياسي في الإسلام هو إن الديني والسياسي كلاهما يتعلقان بالسلطة ويجعلانها قاعدة مادية وجهازا يحقق كل منهما ماهيته وغايته، وأنه في كل مرة يصل الديني إلى أن يصبح قوة غير مباشرة أو موازية ذات” إمكان” فعال في الجماعة فيتحول إلى سلطة تنازع السياسي فإنه لن يتوخى عن”امتحان “هذه القوة الموازية بجميع الأدوات المتوافرة وستكون أولى أدواته الديني نفسه لأنه أقوى الأدوات تأثيرا في الجماعة ذات الإطار المرجعي والقاعدة الإيديولوجية الدينية، وسيظهر الديني دوما في مظهرين :أحدهما (متصلب في الدين ) يتوسل بدرجات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أقصاها بحسب الإمكان، وثانيهما”عملي “يتوسل إلى غاياته عند “السياسي “ب “الطاعة” ولا يبدي أية مقاصد عدوانية أو عصيانية في موقفه من السلطة.
الهوامش:
[1] Mireille estivalézer, les religions dans l’enseignement laïque, paris, p.u.f, 2005, .pp 24-30.يلاحظ بعض الطلبة أن إدراج الدين هو نقطة بداية لحوار اجتماعي متعدد الأسباب البعض منهم من يريد جعل اللائكية المسئولة الأولى عن هذا الحدث لأنها طردت الدذين خارج المدرسة وكل المسائل التي لها علاقة بالدين والمسألة هنا معقدة، ومن بين هؤلاء المؤسسة الدينية التي استغلت هذا الوضع المتمثل في إفلاس نقل المعارف الدينية متطلبا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة العودة إلى التربية الدينية ووضع اللائكية كسبب لها.
2 Belhandiche abdollah, islam et laïcité, thèse de doctorat, université de paris 4 1994.pp152-153.
– Belhindiche abdollah .ib.i.d p 154.
3أنظر في هذا الموضوع براين تيرنر علم الاجتماع والإسلام،مرجع سابق ص 224-223.
4أنظر فاروق عبد السلام، الأحزاب السياسية (الفصل بين الدين والسياسة) ، مطبعة العمالة الجديدة، 1979، ص 83.
5* انظر، فاروق عبد السلام، نفس المرجع _الفصل المتعلق بالفصل بين الدين والسياسة ص ص53_83 أما ظاهرة الفصل بين الدين والسياسة في الإسلام” لا محل للجدال ولاختلاف البتة، على إن الإسلام لا يقبل الفصل بين السياسة شكلا وموضوعا نصا وروحا. فلا اجتهاد مع النص في الإسلام ” ما فرطنا في الكتاب من شيء ” سورة الإنعام 38 فهو الكتاب الوحيد الذي لم يفرط في شيء ولم يفرق بين الدين والسياسة أو بين العبادات والمعاملات والثابت هو أن الإسلام لم يفصل بين الصلاة والزكاة أو بين شعائر دينية ومناهج سياسية، وعلى الرغم من اختلاف الأحزاب في كل كبيرة وصغيرة ورغم كل مما كان بينهم من خلافات وصراعات (الخوارج_ الش يعة _السنة ) لم يختلفوا على الإطلاق حول شمولية هذا الدين ورفضه لكل أنواع التجزئة والتبعيض. فإذا كان هذا واضحا بين المذاهب الاسلامية القديمة، فالأحزاب السياسية الحديثة مازالت فعاليتها متأثرة بما صدر إليها أو استوردته من الفكر السياسي الغربي، فالسياسة في الإسلام فصل من فصول الدين.
6 ـ *انظر تعريف “محمد اركون “للائكية(
Etienne Sacre, Réflexion Sur La Laïcité Beyrouth-karlik .1969.pp.15-16.
7-Abderraouf boulaabi :la légitimité du pouvoir dans la tradition islamique ,thèse université de paris4 pp15-25.
8 -Abderraouf boulaabi :la légitimité du pouvoir dans la tradition islamique , i.b.i.d ,pp-25-30.
9-Durkheim :les formes élémentaires de la vie religieuse –paris ,P.U.F.1960, P50.
10 ـ *حسب جورج بالندي”إنها احد الإشكال التاريخية التي استعملتها الجماعة لتأكيد وحدتها السياسية “.جورج بالنديي: الانثروبولوجية السياسية ن بيروت دار عويدات ص 153.
11- Abderraouf boulaabi la légitimité du pouvoir dans la tradition islamique, thèse de doctorat, Paris IV, 1993, P23.
12- Belhamidech abid O.P.CIT.P.15.
13 براين تيرنر،علم الاجتماع والاسلام،ترجمة ابو بكر احمد باقادر، حدة المملكة العربية السعودية،مكتبة جدة 1990 ص 28
14 براين تيرنر ، نفس المرجع ص 29
15ـ –براين تيرنر ، نفس المرجع ص 30
16 Belhamdach abd O.P.C.I.T.p 45
17 ـ*” أن اصل قيام الدولة ليس موضوعا للأحكام الشرعية – بل موضوع الأحكام الشرعية هو فلسفة الدولة ” انظر: توفيق السيف، نظرية السلطة في الفقه الشيعي المركز الثقافي العربي، المغرب،2002 ص35.
18 ـ belhamadech Abd, op.cit,p.47
19-Jacques Gavillet De Peney, recherche sur la confluence entre la politique et la religion en islam, thése d’état université de paris 7.pp
20- ميربت، في النقد الإسلامي الوضعي، مرجع سابق 2006 ص15
21 ميرث نفس المرجع ص 101.
22ـميرث نفس المرجع ص 102.
23ـانظر عبد الله بلقريز ، الإسلام والسياسة، المركز القومي العربي الدار البيضاء المغرب 2001 ص45
يقول :” إن مقولة الدولة الدينية لا تتمتع في تجربة الإسلام ـ إسلام الأصول ـ إسلام ما بعد الخلافة الراشدة ـ بأي شكل من أشكال الشرعية ـ فمنذ الهجرة تحققت إلى أشكال المجال السياسي عن المجال الديني “لكن مع ظهور الدولة الأموية ثم سليلتها من الدول اللاحقة افتقرت إلى عنصر الكاريزما النبوية مما أبطل العمل بمبدأ الشورى في الحكم وفي التولية مستعيضة عنه بنظام الوراثة. وعلى العموم يمكن القول بان المجال السياسي الإسلامي بشكل مستقل عن المجال الديني بسبب غياب تشريع قرأني له، بل هو ثمرة جهد واجتهاد بشري يترتب على سلم القيمة تنازلا من النبي ( صلى الله عليه وسلم)..إلى الفقهاء. وبهذا ييضيف عبد الإله بلقزيز” التاريخ الإسلامي ـ في أي لحظاته ـ شكلا من أشكال الدولة الدينية على النحو الذي شهدته أوروبا الوسطية المسيحية” ولذا لم نشاهد اصطدام بين الدين والسياسة كما هو في العال المسيحي، بل كان هناك تعايش حقيقي يتمثل في الأمر القرآني ” وأمرهم شورى بينهم”. مما فتح ميدان السياسة على الاجتهاد والاستنجاد بالدين عند احتياج السلطة إلى شرعية نفسها بالدين. كل هذا سيدحض دعوة الحركات الاسلامية فيما بعد دعوتهم إلى العودة إلى إقامة “الدولة الاسلامية ‘ وهذا ما يرفع عنها التذرع بالدين.
24 ـ(انظر… شرعية السلطة في الفقه الإسلامي) نظرية السلطة في الفقه الاسلامي ص46. *إن السلطة ليست حلقة منفصلة عما يحيط بها لأنها كما رأينا ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني، وبما أن طبيعة الحياة الاجتماعية تتغير تبعا لتغير الناس في ثقافتهم ومصادر عيشهم وتفاعلهم مع المجتمعات المحيطة بهم، وهذا التعبير لا ينحصر في جانب واحد بل يعمم الجميع وبهذا تصبح السلطة ـ كموضوع للحكم الشرعي ـ ليست ثابتة على صورة واحدة ونسق واحد على مر العصور، فالطريقة الشرعية التي كانت سائدة تتطابق وزمنها ولا تنعكس على زمن مغاير وإلا أصبح مبالغ في تجميد الواقع وإلغاء طبيعتها التاريخية.فللمسافة الزمنية أهمية كبرى التي توسم كل مجتمع عن غيره بإنسانيته وثقافته وأسلوب حياته بمواصفات يعبر عنها بالسمة الثقافية المحددة للعصر والعاكسة للواقع الاجتماعي
25 الماوردي، الأحكام السلطانية، بيروت، دار الكتاب ،د.ت.ص5 32.
26 علي عبد الواحد وافي، مقدمة ابن خلدون، الجزء الثاني. مصر 1966 ط 2 ص 636 ـ 640.
27 **اما ابن خلدون “يحبذ أن ماط السلطة التي تعتمد مرجعيتها على المعايير السياسية العقلانية ولو كان أصلها ديني، ويرفض سلطة الملك المبنية على السيطرة والقوة. انظر المقدمة ص 368
28.Max weber :revue française de sociologie
29 ـ براين تبريز، علم الاجتماع والإسلام، ص 250.
“من الواضح أن المصادر التي اهتمت بالإسلام في رأي فيبر “إن المسألة الرئيسية في التطور الإسلامي كانت هي سيادة السيطرة الوراثية،كانت الحضارة الاسلامية –لعدة قرون قبل سقوط الدولة العثمانية في العصر الحديث- أمة مجزأة غالى دويلات صغيرة أو تحكمها جيوش مرتزقة في خدمة الدولة الوراثية، وأوضح كيف أن الوراثية لم تكن تتوافق مع الطبقة البورجوازية النشطة وتنظيمات المدن المستقلة والقانون الرسمي المستقل.
30ـ *يقول بلحميدش عبد الله مرجع سابق “يبدو الإسلام كرؤية جديدة لحقيقة العالم وكثورة ضد النظام السوسيو_سياسي للمجتمعات القبلية العربية ما قبل الإسلام” ص44 وهذا بفضل الظاهرة الرانية التي أدخلت بعدا للرسالة، فأصبح المفهوم الإنساني مركزا حول الله.
31ـ يقول براين تبريز،” أن المصلحين المسلمين في القرن التاسع عشر قاموا بتحديد مجموعة جديدة من الدوافع * للإسلام في العصر الحديث ومن تحليلهم لمشاكل التغير الاجتماعي تقريبا يتبع المنهج الفيبري. فلقد كان هناك توازن بين قيم الإصلاح الإسلامي والإصلاح البروتستنتي إلا أن هذا التوازن أمر خادع ” ويرددون بان ” نظرية أو أطروحة الأخلاق البروتستنتية جاءت لتناسب المجتمع الإسلامي وذلك لان المصلحين المسلمين قبلوا الآراء الأوروبية واعتبروها أراء حديثة وقبلوا فكرة الدين التقليدي لا يتفق مع النظرة العلمية، وان عملية الإصلاح احتوت أفكارا تؤدي إلى تغيير المجتمع ”
32ـ مصطلح الدوافع عند فييبر هو ” مجموعة معقدة من المعاني الذاتية والتي تبدو للفاعل نفسه أو للملاحظ كخلفية مناسبة للسلوك موضع النظر، ويعتبر الدافع في علم الاجتماع عبارة عن تفسير لفظي يزودنا بوصف أو تفسير أو تبرير سلوك كان قد جذب أن تباه الفاعل الاجتماعي. وتعدى الدوافع إجابات مقبولة لمثل هذه التساؤلات ( لماذا فهلت هذا ؟)
33 ـ زهية حويرو: قراءة نقدية لأطروحة برهان غليون عن علاقة الدين والدولة في الماضي والحاضر العربيين الإسلاميين، مجلة مقدمات عدد 10-1997م-36-43.
انظركذلك ،
abdrraouf boulaabi :chap.(les différentes approches contemporaines.
34 ـ وهنا نرى عبد الإله بلقزيز “لقد نتج عن هذا خطاب الفصل وخطاب الوصل….الخ ودون الحاجة في الدخول إلى كثير من التفصيل لبيان تلك الخلفية السياسية لموضوع ذلك الجدل.نكتفي بالتذكير بأنه جدل ترتب عنه أطروحتين شديدتي الارتباط بالصراع السياسي وبرهانات السلطة لدى كل فريق: تذهب الأولى إلى الدفاع عن وجوب فك العلاقة بين الديني والسياسي، بين الدين والدولة، فتبحث لنفسها، في النصوص والتاريخ عما تبرر به دعواها وستحصل به الحجة الشرعية. فيما ذهب الفريق الثاني إلى وجوب الدفاع عن وحدة الديني والسياسي، الشرعية والدولة ساعية هي الأخرى إلى التماس الأسانيد الشرعية والتاريخية لدعواها وكلاهما يتحركان على خلفية مطلبين سياسيين:علمية الدولة، وتطبيق الشريعة الاسلامية “. إلا أن هذا الموضوع تعرض له الاستاذ غليون “بإسهاب من جوانب متعددة * والملاحظ انه على الرغم من الخلفية الثقافية عير الدينية لمعظم الحركات بات الشأن الديني من مشمولات سلطتها بل ملكيتها، لمن تفطن الجميع بذلك الفارق بين النص المرجعي وبين الواقع في الحسبان مما يطرح مسألة موضوعية المجتمع وعلاقته بعقيدته وتراثه الديني ويتجسد ذلك في واقع التكوين الثقافي له. حيث تحتل الفكرة الدينية موقعا مميزا في منظومة الأفكار العامة السائدة. أن الأنساق الاجتماعية وتفاعلها في إطار البناء الاجتماعي تعمل على استثمار الرأسمال الديني وتجنيده في الصراع السياسي ويتجسد أكثر في تصنيف الفئات الاجتماعية التي تمثل الحركات مهما كان طابعها السياسي والإسلامي ” إن النصوص الدينية لم ترسم شكلا للنظام السياسي ولا حددت الآيات عمل الاجتماع السياسي للمسلمين….فإننا لا نعثر على شيء في النص القرآني يختص بحقل المعاملات السياسية.إذ نلاحظ غيابا للتشريع في المجال السياسي “2 كل هذا هيا مناخا للانقسام والصراعات الطاحنة. عبد الإله بلقزيز مرجع سابق ص 31
35ـ عبد المجيد الشرقي: هل الفقه وأصوله قابلان للتجديد؟ مقدمات الدار البيضاء، 2000م. 9
36-ايمن عبد الرسول، مرجع سابق، ص 108.
37ـهشام جعيط، الفتنة: جدلية الدين والسياسة ، بيروت، دار الطليعة، 1992، ص 37.
38 ـ هشام جعيط: الفتنة جدلية الدين والسياسية، دار الطليعة، بيروت، 1992م، ص37-38.
39هشام جعيط نفس المرجع، ص 62-83
40ـ محمد عابد الجابري، في قضايا الفكر والدين، مقدمات، عدد 10، ص51.
41- Jacques Gavillet De Peney, recherche sur la confluence entre la politique et la religion en Islam, o.p.c.it.,pp
*هذه العبارة هي محل نقاش لان القران يصور لنا هذا الدين يتصف بالسمو على كل شيء “قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون……”وهذا دليل قاطع على سعة رحب الإسلام.
42-قد لاحظ فيبر “إن الإسلام فشل في تطوير قانون عقلاني رسمي وذلك لأن القانون المقدس كان تحت سيطرة الدولة والدوائر السياسية.ولقد بقي النظام السياسي منغمسا داخل التراث الديني الذي يؤكد على قيام قيم مثل المحاكاة ورفض البدع” انظر براين تيرنر مرجع سابق ص 252.
43فهمي جدعان:سالمحنة ،بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام ،عمان الأردن ، دار الشرق للنشر والتوزيع -.1989ص 15
44أنظر رضوان السيد .الما وردي حسن تسهيل النظر وتعجيل الظفر بيروت المركز الإعلامي للبحوث ص293.
45J Freund ,l’essence de politique ,éd Sirey, paris ,p538, 1986.
46أبو الحسن الماوردي “الأحكام السلطانية والولاية الدينية”ط2 ،بيروت ،دار الكتاب العربي 1972. ص5
 arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف