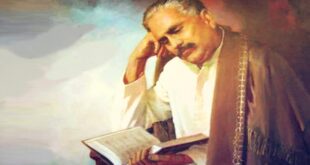أزمة الأمة والخروج من المأزق
د\ محمد أحمد عبد السلام
إن الأمة الإسلامية ودولنا ممزقة وفي أسوء حالاتها داخليًّا وخارجيًّا بشكل لم يسبق له مثيل، ولن يرحمنا التاريخ أو يلتمس لنا أحفادنا الأعذار على ضياع كل هذه الفرص للإصلاح، وأخص بالذكر ثورات الربيع العربي وما تابعها من صعود التيارات الإسلامية لتقلد السلطة في بعض الدول؛ لكن التجربة فشلت؛ وذلك بسبب عوامل فكرية وعقلية وسياسية؛ وأصبحنا من حينها نمر بأزمة قلبية، فلا حب ولا عقل ولا فكر ولا دولة ولا بلد ولا وطن ولا أرض، وفرطنا – من قبل- في الأسرة والعائلة والقبيلة والعادات والتقاليد والهوية الثقافية.
لكل مجتهد نصيب، والجزاء من جنس العمل، ولله آيات مقروءة (القرآن)، وأخرى مرئية منظورة، الكون، ووجب الإيمان بها جميعًا، والإيمان بتلك الآيات الكونية يكون باحترامها والعمل على الأخذ بها، وهو في حدِّ ذاته صدق مع الله عز وجل في العمل والإصلاح، (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه)، إيمان وعمل؛ إيمان بالآيات الكونية وما خلقه الله، وعمل بها لتحقيق النجاح.
ويقول ابن القيم: “لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله (تعالى)، وإنّ تعطيلها يقدح التوكل في النفس، وإنّ تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولابد من هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع؛ فلا يجعل العبد عجزه توكلًا ولا توكله عجزًا”.
إن السلف الحقيقي يقرر في وضوح وجلاء أن الأخذ بالسبب طاعة، والاعتماد عليه كفر، وترك السبب معصية، فبعيدًا عن تلك المهاترات الجدلية العقيمة([1]) من بعض المتشدقين بالدين، ورَدًّا على كل من يحاول اتهام الدين بتأخر المسلمين، فالإسلام استطاع تحويل من يأكلون الجعلان ويعيشون البادية إلى أن يكون لهم وزنٌ بين الأمم ليبدأ عهدٌ جديدٌ، لا أقول للعرب فحسب في شبه الجزيرة العربية، بل للمسلمين في كل مكان.
لحظة فاصلة في حياة الأمة:
وبالنظر إلى لحظة نشأة النظام الإسلامي السياسي نجد أنه يرجع “إلى لحظة معينة من الخبرة التاريخية لتلك الجماعات التي قطنت شبه الجزيرة العربية لحظة تاريخية معينة اقتضت أن تتحولها من مستوى حضاري أدنى إلى مستوى حضاري أرقى، قفزة من المجتمع البدوي إلى مستوى الجماعة الواحدة (الأمة)، وجاء هذا التحول من القبيلة إلى الجماعة السياسية الموحدة مع مجيء الإسلام في غضون القرن السابع، وهذه النشأة تطرح فى الواقع عديدًا من القضايا وتثير العديد من الملاحظات”.([2])
ونجد “أن تلك اللحظة جعلت المسلمين يتسيدون العالم لقرابة اثني عشرة قرنًا، من أصل أربعة عشر قرنًا منذ نشأة الإسلام، مدركين أهمية التعاملات السياسية ومسايرة ركب العالم؛ بل تصدر مشهده، وربما لم تحدث تلك الانتكاسة والانحطاط المسلمين إلا عند ابتعادهم عن التفكير بشكل علمي في جميع أمورهم السياسية، واعتنائهم بتلك القوة السياسية؛ فأدى ذلك إلى تفرق وتمزق الأمة الإسلامية إلى شيعٍ ودويلات وطوائف وجماعات”([3])، وصار كلٌ منا لا يهمه أخيه؛ مما أدى مع وجود الفتن والنزاعات إلى ضعف الأمة الإسلامية، كما أدى بدوره إلى قابلية الدول الإسلامية إلى الاستعمار، وضياع ثروات الأمة، وإضعافها على جميع الأصعدة.
بين الإرهاب والعلمانية:
أما نحن اليوم وبعد كل هذه السنوات فإننا نتذيل قائمة العالم في كل شيء، كما أن الإسلام هو المتهم الأول محليًّا وعالميًّا، إقليميًّا ودوليًّا، لاسيما بعد ظهور الدولة الإسلامية “داعش” على السطح، وتبنيها للأحداث الأخيرة في فرنسا، وكذلك كل الأحداث المتوالية عن اتهام الإسلام بالإرهاب، ونحت تمثال الإرهاب على مقاس المسلمين في أي مكان، وفي هذا السياق لابد أن نعود إلى ما شرَّعه الإسلام لنعلم كيف عمل على تحديد السياسة التي تتعامل بها الدول الإسلامية.
لاسيما مع هذه الهجمات الشرسة والمتكررة والمتجددة، من العالم أجمع على أي حكومة إسلامية، أو أي عمل إسلامي يخص دولة تنتمي للدين الإسلامي، وأصبح الغرب يحارب تلك الدول بدعوى الإرهاب، كما أن العلمانيين المسلمين يحاربون فكرتها منقسمين إلى فريقين إما بدعوى الإرهاب، وإما بدعوى التأخر والتخلف، محاولين إلصاق التهمتين بالإسلام تارة، أو الحركات الإسلامية على تنوعها تارة أخرى.
وهذا يعطي مؤشرًا خطيرًا لتلك الحرب الضروس التي نواجهها نحن المسلمون من جهة والإسلام السياسي من جهة أخرى، فالقضية كما نرى باتت محاربة الإسلام في كل صوره التي يظهر عليها، ومحاربة رجاله أو تهميشهم أو شرائهم لمساندة هذه الحرب لقتل السياسة الشرعية؛ بل وأدها، وهذا يرجع إلى ثلاثة أمور:
الأول: التأثر بالغرب العلماني الذي ثار على الكنيسة “اشنقوا آخر قسيس بأمعاء آخر إقطاعي”، فالقارئ في التاريخ يعلم أن العلمانية في الغرب قامت بعد سطوة الكنيسة وتجبرها في البلاد؛ إذ علم الغرب أنه لا حياة لهم مع هذه السطوة المتجبرة والمتحجرة والمتخلفة في الوقت ذاته؛ إذ ساد الظلام، وتفشى الجهل، وعاشت البلاد أسوأ حالاتها؛ من هنا قامت فكرة فصل الدين عن الدولة، ونادى القوم بعد ذلك أن هذه الفترة بما فيها من رجال دين لا تعبر عن ذات الدين، محاولين تجميل الصورة فقالوا: “الدين لله والوطن للجميع”.
الثاني: حالة الجهل والتأخر التي تمر بها البلاد الإسلامية الآن، ولك أن تجعل التأخر في الأخلاق بل أزمة الأخلاق التي نعيشها هي الأساس، هذا مع الانبهار بالغرب لما حققه من إنجازات؛ ولن أكون متجنيًا إن قلت أن هذا الانبهار وتلك النظرة له ومحاولة تقليده لا تكون من أجل مصلحة عامة؛ بل هي من أجل مصالح شخصية بدليل أننا نجد التقدم المالي والعلمي أحيانًا لمن يتقلد مناصب، والتأخر للدولة في الوقت نفسه، هذا مع محاولة الابتعاد عن الدين الذي يحارب السرقة ويجرم الرشوة ويعاقب على غياب الضمير؛ لذا فإن الدين بالنسبة له يضيع عليه الفرصة للتقدم الشخصي، كما أنه يجعل له من نفسه رقيبًا على أعماله؛ لذا قامت المناداة بفصل الدين عن الدولة في العصر الحاضر من قِبَل المسئولين والعلمانيين الذين وقفوا عند تسلط الكنيسة في الغرب فرددوا كلمات جوفاء “دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله”.
الثالث: محاربة المسلمين لدينهم عن جهل، وتلك قضية غاية في الخطورة، تضرب في أعماق التيار الإسلامي، فمن جهة – كما أشرنا- رجال الدين الذين تم شراؤهم، وكذلك من لا يدركون خطورة الموقف ويتصدرون المشهد دون وعي وفهم، وكذلك من تجمدت عقولهم عند عصر قديم، محاولين العيش في هذه الحقبة من الزمن، غير متذكرين أن الدين صالح لكل زمان ومكان، وأن هناك فروقًا كبيرة وجب مراعاتها في هذا الزمان، وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) سمَّى من يأتي بعد جيل الصحابة على الإيمان بإخوانه: “وددت أني قد رأيت إخواننا، فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك، قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض”([4])، كل هذا جعل من البسطاء والشباب وأطياف المجتمع الإسلامي من يرفض الرجوع إلى تلك الشخصيات، والجنوح إلى النماذج العلمانية أو الليبرالية ناظرين إليها نظرة المُخَلِّصْ، هؤلاء المخلصين الذين تربوا على أيدي الغرب بعد ارتمائهم في أحضانهم ظانين أنه الخلاص من حالة التأخر الراهنة يمينًا ويسارًا، فتغيرت ثقافتهم بطبيعة الحال وتبدلت لهجتهم ونادوا ببعض التغيير، ومن بين ذلك القول بضرورة فصل الدين عن السياسة، وهو أمر مشاهد، لاسيما لو نظرنا إلى المجتمع من حولنا بعين الاعتبار أنه مجتمع عادي ثقافته ضحلة ولن يغوص في أعماق الأشياء ليعرف أسبابها ومسبباتها، كما هو حال المجتمع الإسلامي والعربي للأسف الشديد.
نافذة الخروج:
لذا وجب على الباحثين المسلمين في جميع مجالاتهم إعطاء رؤية صحيحة مبنية على العلم، ومنها التأصيل لمفهوم السياسة الشرعية وتقريب مفهومها لكل المسلمين قاطبة؛ لندرك ما إذا كنا نخطو نحو التقدم لأمتنا أم أننا نضيع مجدًا تليدًا صنعه أجدادنا عبر قرون عدة، كما أننا نفرط في حق الإنسانية أن تسير وفق المنهج الرباني الإلهي في التشريع، وهل يستطيع العبد أن يشرع كالإله؟! هذا في أمور التشريعات الربانية من الحلال والحرام المنصوص عليها في أبواب التعامل في الفرد والمجتمع وتدبير أمور الناس، ومردها جميعًا إلى الكليات مثل: العدل ضد الظلم، والسياسة كلها تقوم على المصالح المرسلة، وتحتاج إلى عقول تضبط هذه المصالح في كل عصر ومصر؛ أما في مجال الدنيا فنحن منفتحون على الجميع، في ظل تكامل الحضارات نأخذ ونرد ونتعلم ونعلِّم، فلا يعقل ألا نطبق قانون المرور الذي ينظم مرور السيارات، فقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم) “أنتم أعلم بأمور دنياكم”، كما أننا في الوقت ذاته ندين لقوله (صلى الله عليه وسلم): “فأعطوا الطريق حقه”، أو ندرك ما يتوجب علينا البدء به.
[1]. هذه المهاترات التي استولت على العقل المسلم، واستحوذت على فكر الساسة والمفكرين دون استخدام ذاك الجهد والعقل في تقدم الأمة، أو مناقشة حالتها المتردية للوصول إلى تغيير سريع.
[2]. المدخل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية، أ.د. منى أبو الفضل، دار السلام، ط1، 1434هـ، 2013م، ص 151.
[3]. فالناظر حوله يعلم أنه في هذه الفترة الأخيرة قد قسمت كثير من الدول العربية والإسلامية، وتفاوت هذا التقسيم بين التقسيم في الأراضي مثل السودان، وبين التقسيم السياسي والفكري والخراب والدمار، لا سيما بعدما كنا نرجوه من نهضة للدول العربية بعد سلسلة الثورات على حكوماتها الاستبدادية، إذ أدى إلى نكسة كبيرة جدًّا (ليبيا، سوريا، مصر، اليمن)، كما نجد الاحتلال الصهيوني يستغل تلك المتغيات السياسية الكبرى كي يزيد من غطرسته تجاه الفلسطينيين، والأراضي المقدسة، وإن كان من وجهة نظري لا يحتاج إلى هذه التغيرات أو تمزق الدول العربية والإسلامية، إذ إن ممارساته تزداد على مدار ستين عام دون رادع، ولا شك أن كل ما يحدث للدول الإسلامية والعربية في المنطقة راجع لفشلهم في إدارة العملية السياسية، ولا يستطيع منصف إهمال الدور السياسي داخليًّا وخارجيًّا في كل ما يحدث.
[4]. صحيح مسلم، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل، (1/218)، رقم: (249).
 arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف